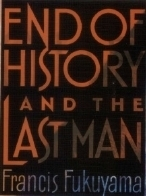فشلت كل محاولات نقل الحداثة إلى شرق أوروبا قبل أن تدخلها الاشتراكية، فالتصنيع، وتوفير الكهرباء، والتعليم ونشر المعرفة والرياضة المنظمة، والرعاية الصحية، هي كلها أمور ينسبها الأوروبيون الشرقيون للاشتراكية، وتحقق ذلك من خلال قدر كبير من العنف والقسوة، ولقد تم الإنجاز الاشتراكي نحو التحديث في مرحلة من تاريخ الصناعة العالمية تطلبت هياكل الإنتاج الكثيف، إلا أن «الخاصية المتغيرة لعملية التصنيع على امتداد التاريخ الإنساني» وبلوغ الحياة الاقتصادية في الربع الأخير من القرن العشرين درجة عالية من التعقيد والكثافة المعلوماتية – نتيجة معدلات مذهلة من الابتكارات التكنولوجية في المجتمعات الرأسمالية – جعلت سياسات التخطيط المركزي عديمة الجدوى.
أما رئيس وزراء سنغافورة السابق «لي كوان يو» فيرى أن السلطوية الأبوية تناسب الثقافة الكونفوشية أكثر من الفردية، وهو الاتجاه الذي شاركته فيه قيادات التقدم في آسيا باعتبار أن هذا الطراز من السلطوية أكثر تفوقاً وتميزاً من الليبرالية الغربية في إفرازه لقطاعات أعلى تعليماً وأشد انضباطاً وهي الشروط اللازمة لمجتمع متقدم تكنولوجياً في حقبة ما بعد الصناعة. وربط القيم بالنظام السياسي والاجتماعي.
والليبرالية الجديدة لم تصمد طويلاً في دول العالم الأول نفسه، فقد تنامت قدرة أصحاب المصالح المالية الكبرى في السيطرة على السياسة إلى حد هدد العملية الديمقراطية وأدى إلى فقدان ثقة المواطن الغربي في ساسته وبرلمانه، ووصل هذا الحد إلى ذروته أخيراً في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة على هيئة احتجاجات مستمرة وغضب شعبي عارم، بل إن «ميدان التحرير» المصري أصبح مثالاً للأمل والملاذ الأخير لهذه الشعوب، وعليه يحاول العالم الأول الآن العودة إلى القواعد التي رفضتها الليبرالية الجديدة، وهي القواعد التي وضع أسسها الاقتصادي «كينز»، وتبناها الفكر الاجتماعي والسياسي الأمريكي لعلاج آثار الأزمة الكبرى في أوائل الثلاثينات والتي أدت إلى تعظيم دور الدولة في توجيه الاقتصاد (اتهم الرئيس روزفلت بأنه اشتراكي مثل الاتهامات التي توجه من اليمين الأمريكي للرئيس أوباما حالياً).
إن هذه الملاحظات في مجملها ليست دفاعاً عن النماذج التقليدية لتدخل الدولة ولا حجة ضد الاعتماد على آليات السوق، بل يجب فهمها على أنها محاولة للتحذير ضد الأخطار التي تنجم عن المبالغة في الحماسة الأيديولوجية التي يتصف بها الليبراليون الجدد، ومنها نؤكد أن السياسات الاقتصادية بالمفهوم الليبرالي حتى ولو كانت ناجحة فإنها لا تميل إلى توليد الشروط المناسبة للتنمية الشاملة، فمحركات التنمية هي سلسلة من العناصر، منها: التعليم والمهارات والتكنولوجيا، والأسواق التنافسيية ليست كافية لتخصيص هذه الموارد بكفاءة، ومن أجل ذلك فالاجتهاد والرؤى المتعددة مطلوبة من أهل الفكر انطلاقاً من كون «إشكالية التنمية» هي جوهر المشروع المصري بعد ثورة 25 يناير متحررين في اجتهاداتنا من القوالب والصيغ النمطية.
ليس جديداً في أدبيات التنمية الشاملة، فلقد سبق لعالم الاجتماع الألماني «ماكس فيبر» أن أكد – منذ قرابة مائة عام توافق الرأسمالية والقيم البروتستانتية وهذا ما فعله من قبله آدم سميث في القرن الثامن عشر، وهكذا نرى أن الحوار ما زال دائراً حول أنماط التحديث وأن القضية لم تحسم لصالح الليبرالية كما يدعى فوكوياما، وإنما هناك عدة بدائل على الساحة العالمية لكل منها نظريتها وبراهينها.
وأما الليبرالية فإنها تعتبر أن الاختيار واضح وأن هناك طريقاً واحداً للتنمية يجب اتباعه وهو المنهج الذي يتلاءم مع الفكر الليبرالي الجديد باتباع استراتيجية للنمو من خلال اندماج كامل في النظام الرأسمالي العالمي أو ما يطلق عليه «التحديث من خلال التدويل». وتدعو المؤسسات الدولية المساندة لليبرالية (البنك الدولي وصندوق النقد) إلى استراتيجية لفتح منافذ الاقتصاد الوطني كافة أمام العالم الخارجي بحجة التوجه نحو اقتصاد تصديري في مرحلة تالية، ونتيجة لتطبيق هذه الفلسفة فإن الكثير من الحكومات الوطنية تعاني تقلصاً في قدراتها على تعويض الخاسرين من برامج الإصلاح الاقتصادي وفي قدرتها على التعامل مع التوترات. الاجتماعية بشكل عام، ولأن هذا العلاج الليبرالي الجديد علاج مؤلم وله تكاليف اجتماعية كبيرة، نجد أن الإصلاحات تبدأ من أعلى دون مشاركة القوى المؤثرة في المجتمع وحتى الهيئات التشريعية لا يكون لها دور في وضع السياسة الاقتصادية، بل مجبرة على قبولها مثل: (اليونان وإسبانيا وإيطاليا ودول أوروبا الشرقية)، ولذلك فإن الإصلاحات الليبرالية الجديدة، وحتى حينما تصبح ذات معنى اقتصادي، فإنها بالضرورة تضعف المؤسسات النيابية على عكس ما يتوقعه الليبراليون الجدد.
وليسمح لي القاري بملاحظة أخيرة قد تساعدنا في الحوار حول التنمية والديمقراطية، وهي أنه نتيجة تدليس فكري واسع المدى صارت كلمتا الديمقراطية والليبرالية مترادفتين، إلا أنه يجب أن نعي أنهما تعبران عن معانٍ مختلفة، ولقد أكد فرانسيس فوكوياما هذا الفصل بينهما – في كتابه عن نهاية التاريخ – بقوله: «إن الإسلام يشكل إيديولوجية متماسكة ومتناسقة تماماً مثل: الليبرالية والشيوعية، وله ميثاقه الروحي وعقيدته حول العدالة السياسية والاجتماعية»، ويضيف فوكوياما: «إن الإسلام يتوافق مع الديمقراطية وبالأخص مبدأ الحقوق المتساوية للبشر إلا أنه من الصعب مصالحة الإسلام مع الليبرالية»، وإذا كانت تلك قناعة المفكرين في الغرب، ألا تستحق مفاهيم الليبرالية إذن ومدلول كلماتها تفحصاً منا بشكل أعمق؟.
المصدر: مجلة وصلة | الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب | المجلد/العدد: ع 1 | التاريخ الميلادي: 2012 | الصفحات: 8 - 9 | المؤلف الرئيسي: دولار، شريف (مؤلف)
الإسلام يتوافق مع الديمقراطية.. لكن من الصعب مصالحته مع الليبرالية. - فوكوياما
سيطرة أصحاب المصالح المالية الكبرى على السياسة تهدد الديمقراطية.
وفشلت الاشتراكية «كنظام اقتصادي» نظراً لعجزها عن تحقيق المستويات التالية من الحداثة المرتبطة بحرية وإبداعات الأفراد بعيداً عن هيمنة الدولة. ولقد اعتمد «فرانسيس فوكوياما» - الذي اشتهر بفكرته عن نهاية التاريخ – على هذا التحليل الخاص بفشل النموذج الاشتراكي في الانتقال إلى مرتبة أعلى من التحديث ليؤكد أن الليبرالية قد انتصرت وأنها السبيل الوحيد للتقدم، وعلى النقيض يؤكد خبراء التنمية في شرق آسيا أن المجتمعات الآخذة في النمو يجب أن تقودها صفوة تكنوقراطية.أما رئيس وزراء سنغافورة السابق «لي كوان يو» فيرى أن السلطوية الأبوية تناسب الثقافة الكونفوشية أكثر من الفردية، وهو الاتجاه الذي شاركته فيه قيادات التقدم في آسيا باعتبار أن هذا الطراز من السلطوية أكثر تفوقاً وتميزاً من الليبرالية الغربية في إفرازه لقطاعات أعلى تعليماً وأشد انضباطاً وهي الشروط اللازمة لمجتمع متقدم تكنولوجياً في حقبة ما بعد الصناعة. وربط القيم بالنظام السياسي والاجتماعي.
والليبرالية الجديدة لم تصمد طويلاً في دول العالم الأول نفسه، فقد تنامت قدرة أصحاب المصالح المالية الكبرى في السيطرة على السياسة إلى حد هدد العملية الديمقراطية وأدى إلى فقدان ثقة المواطن الغربي في ساسته وبرلمانه، ووصل هذا الحد إلى ذروته أخيراً في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة على هيئة احتجاجات مستمرة وغضب شعبي عارم، بل إن «ميدان التحرير» المصري أصبح مثالاً للأمل والملاذ الأخير لهذه الشعوب، وعليه يحاول العالم الأول الآن العودة إلى القواعد التي رفضتها الليبرالية الجديدة، وهي القواعد التي وضع أسسها الاقتصادي «كينز»، وتبناها الفكر الاجتماعي والسياسي الأمريكي لعلاج آثار الأزمة الكبرى في أوائل الثلاثينات والتي أدت إلى تعظيم دور الدولة في توجيه الاقتصاد (اتهم الرئيس روزفلت بأنه اشتراكي مثل الاتهامات التي توجه من اليمين الأمريكي للرئيس أوباما حالياً).
إن هذه الملاحظات في مجملها ليست دفاعاً عن النماذج التقليدية لتدخل الدولة ولا حجة ضد الاعتماد على آليات السوق، بل يجب فهمها على أنها محاولة للتحذير ضد الأخطار التي تنجم عن المبالغة في الحماسة الأيديولوجية التي يتصف بها الليبراليون الجدد، ومنها نؤكد أن السياسات الاقتصادية بالمفهوم الليبرالي حتى ولو كانت ناجحة فإنها لا تميل إلى توليد الشروط المناسبة للتنمية الشاملة، فمحركات التنمية هي سلسلة من العناصر، منها: التعليم والمهارات والتكنولوجيا، والأسواق التنافسيية ليست كافية لتخصيص هذه الموارد بكفاءة، ومن أجل ذلك فالاجتهاد والرؤى المتعددة مطلوبة من أهل الفكر انطلاقاً من كون «إشكالية التنمية» هي جوهر المشروع المصري بعد ثورة 25 يناير متحررين في اجتهاداتنا من القوالب والصيغ النمطية.
ليس جديداً في أدبيات التنمية الشاملة، فلقد سبق لعالم الاجتماع الألماني «ماكس فيبر» أن أكد – منذ قرابة مائة عام توافق الرأسمالية والقيم البروتستانتية وهذا ما فعله من قبله آدم سميث في القرن الثامن عشر، وهكذا نرى أن الحوار ما زال دائراً حول أنماط التحديث وأن القضية لم تحسم لصالح الليبرالية كما يدعى فوكوياما، وإنما هناك عدة بدائل على الساحة العالمية لكل منها نظريتها وبراهينها.
وأما الليبرالية فإنها تعتبر أن الاختيار واضح وأن هناك طريقاً واحداً للتنمية يجب اتباعه وهو المنهج الذي يتلاءم مع الفكر الليبرالي الجديد باتباع استراتيجية للنمو من خلال اندماج كامل في النظام الرأسمالي العالمي أو ما يطلق عليه «التحديث من خلال التدويل». وتدعو المؤسسات الدولية المساندة لليبرالية (البنك الدولي وصندوق النقد) إلى استراتيجية لفتح منافذ الاقتصاد الوطني كافة أمام العالم الخارجي بحجة التوجه نحو اقتصاد تصديري في مرحلة تالية، ونتيجة لتطبيق هذه الفلسفة فإن الكثير من الحكومات الوطنية تعاني تقلصاً في قدراتها على تعويض الخاسرين من برامج الإصلاح الاقتصادي وفي قدرتها على التعامل مع التوترات. الاجتماعية بشكل عام، ولأن هذا العلاج الليبرالي الجديد علاج مؤلم وله تكاليف اجتماعية كبيرة، نجد أن الإصلاحات تبدأ من أعلى دون مشاركة القوى المؤثرة في المجتمع وحتى الهيئات التشريعية لا يكون لها دور في وضع السياسة الاقتصادية، بل مجبرة على قبولها مثل: (اليونان وإسبانيا وإيطاليا ودول أوروبا الشرقية)، ولذلك فإن الإصلاحات الليبرالية الجديدة، وحتى حينما تصبح ذات معنى اقتصادي، فإنها بالضرورة تضعف المؤسسات النيابية على عكس ما يتوقعه الليبراليون الجدد.
وليسمح لي القاري بملاحظة أخيرة قد تساعدنا في الحوار حول التنمية والديمقراطية، وهي أنه نتيجة تدليس فكري واسع المدى صارت كلمتا الديمقراطية والليبرالية مترادفتين، إلا أنه يجب أن نعي أنهما تعبران عن معانٍ مختلفة، ولقد أكد فرانسيس فوكوياما هذا الفصل بينهما – في كتابه عن نهاية التاريخ – بقوله: «إن الإسلام يشكل إيديولوجية متماسكة ومتناسقة تماماً مثل: الليبرالية والشيوعية، وله ميثاقه الروحي وعقيدته حول العدالة السياسية والاجتماعية»، ويضيف فوكوياما: «إن الإسلام يتوافق مع الديمقراطية وبالأخص مبدأ الحقوق المتساوية للبشر إلا أنه من الصعب مصالحة الإسلام مع الليبرالية»، وإذا كانت تلك قناعة المفكرين في الغرب، ألا تستحق مفاهيم الليبرالية إذن ومدلول كلماتها تفحصاً منا بشكل أعمق؟.
المصدر: مجلة وصلة | الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب | المجلد/العدد: ع 1 | التاريخ الميلادي: 2012 | الصفحات: 8 - 9 | المؤلف الرئيسي: دولار، شريف (مؤلف)