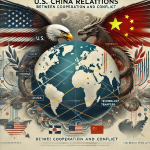وفقًا لما ورد في US Foreign Policy Towards China ضمن كتاب THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF US FOREIGN POLICY IN THE INDO-PACIFIC، شهدت السياسة الأمريكية تجاه الصين بعد الحرب الباردة درجة من الاتساق، حيث اعتُبر دمج الصين في النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة وسيلة لتعزيز المصالح الأمريكية، كما أكد كلينتون وأوباما على أهمية التعاون مع الصين رغم الاختلافات. إلا أن انتخاب دونالد ترامب عام 2016 أدخل خطابًا تصادميًا، متهمًا الصين باستغلال الولايات المتحدة اقتصاديًا، كما أثار الجدل بشأن سياسة الصين الواحدة وعلاقته مع تايوان. انعكس هذا النهج في استراتيجيته للأمن القومي التي صنفت الصين كقوة "مراجعة" تسعى لتقويض القيم الأمريكية، مما أدى إلى توترات دبلوماسية داخلية ودولية، خصوصًا بين حلفاء واشنطن في آسيا. رغم تناقضات خطاب ترامب، إلا أن تصاعد الشكوك تجاه الصين لم يكن جديدًا، حيث شهدت إدارة أوباما في سنواتها الأخيرة موقفًا أكثر تشددًا تجاه قضايا مثل التجسس السيبراني ونقل التكنولوجيا القسري. عند تولي جو بايدن الرئاسة وسط جائحة كوفيد-19، تفاقمت التوترات مع الصين، خاصة مع اتهام واشنطن لبكين بارتكاب إبادة جماعية ضد الأويغور. ركزت سياسة بايدن على تعزيز التحالفات الأمنية مثل الحوار الرباعي، مؤكدًا على ضرورة التزام الصين بالنظام الدولي القائم على القواعد. أثار هذا الخطاب تساؤلات حول دخول العالم في حرب باردة جديدة، غير أن العوامل التاريخية والأيديولوجية ما زالت تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد ملامح العلاقة المتوترة بين القوتين.
سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين في القرن الحادي والعشرين: حرب باردة جديدة؟
على مدى معظم حقبة ما بعد الحرب الباردة، كانت هناك درجة معينة من الاتساق طويل الأمد في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصين، حيث اعتُبر أن دمج الصين في الهياكل القائمة للحكم الاقتصادي والسياسي العالمي التي تقودها الولايات المتحدة يخدم المصالح الأمريكية على أفضل وجه. في عام 1996، جادل الرئيس كلينتون بأن "الانخراط، وليس العزلة، هو أفضل وسيلة لتعزيز مصالح أمريكا مع الصين". وقال إن على واشنطن أن "تشارك الصين في مجموعة واسعة من القضايا... لمواصلة تعزيز التعاون مع التعامل بحزم مع خلافاتنا" (Clinton, 1993). في عام 2014، ومع تطور الصين وتحديثها لتصبح أكثر مركزية في الخطاب السياسي الأمريكي، صرّح الرئيس أوباما بأن "الولايات المتحدة ستواصل السعي لعلاقة بنّاءة مع الصين... وفي هذا الانخراط سنظل صريحين بشأن أماكن وجود الخلافات" (White House, 2014).
في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، أدخل دونالد ترامب خطابًا أكثر صخبًا وتصادمية. فقد صرّح بأن الصين مذنبة بـ"اغتصاب" الولايات المتحدة (BBC, 2021) وأنها "تمتص دماءنا" (Santucci, 2015)، في محاولة لتقديم نفسه كمدافع عن المصالح الأمريكية التي تم استغلالها، بدلاً من خدمتها، من خلال تعميق التكامل مع الصين. أدى هذا إلى ملاحظات بأن ترامب كرئيس قد أدخل اضطرابًا جديدًا وغير متوقع في علاقة أمريكية-صينية كانت مستقرة نسبيًا من قبل (Daojiong, 2017). من الأمثلة المبكرة على هذا النهج مكالمة ترامب الهاتفية مع رئيسة تايوان تساي إنغ ون في ديسمبر 2016، والتي كسرت الأعراف الدبلوماسية التي استمرت منذ عام 1979 والتي تنص على عدم تواصل رؤساء الولايات المتحدة (أو رؤسائها المنتخبين) مباشرة مع رئيس تايواني. وبعد ذلك بوقت قصير، شكك في منطق سياسة الصين الواحدة قبل أن يعيد الالتزام بها لاحقًا (BBC, 2017).
سياسة الصين الواحدة هي اعتراف واشنطن بجمهورية الصين الشعبية كممثل وحيد للصين، وبالتالي فهي تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين بدلاً من تايبيه. كما أنها تعني الاعتراف بموقف الصين (مبدأ الصين الواحدة) بأن تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، ولكن دون الموافقة على هذا الموقف (Bush, 2017). يسمح هذا للولايات المتحدة بدعم وحتى الدفاع عن تايوان، عبر قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، الذي تم توقيعه لتعويض انسحاب واشنطن من العلاقات الدبلوماسية مع تايوان لصالح بكين. وعلى الرغم من أنه ليس معاهدة دفاع ملزمة، إلا أن القانون يسمح بدعم وبيع المعدات العسكرية لتايوان. وقد أيدت هذه السياسة جميع الإدارات الأمريكية منذ دخولها حيز التنفيذ، وكان ترامب الزعيم الوحيد الذي تساءل علنًا عن قيمتها.
أكدت الجدل الذي أثارته مكالمة ترامب مع تساي إنغ ون، إلى جانب عدم يقينه الواضح بشأن سياسة الصين الواحدة، الأهمية المستمرة لتايوان في العلاقة الأمريكية-الصينية. وبالتشكيك في السياسة، كان يُنظر إلى ترامب في بكين على أنه يقوض سيادة الصين، لأن ذلك يشير إلى أن فكرة "وجود صينين" - وربما وجود تايوان مستقلة - لم تعد غير واردة في واشنطن. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين "قلقة للغاية" بشأن تداعيات تصريح ترامب على وحدة أراضيها (Chin, 2016). كما احتجت بكين منذ فترة طويلة على بيع المعدات العسكرية الأمريكية لتايوان، وهو أمر أيدته كل إدارة أمريكية في حقبة ما بعد الحرب الباردة.
أدى خطاب ترامب غير المتوقع تجاه الصين إلى عواقب محلية ودولية. محليًا، دفع ترامب الخطاب السياسي حول الصين إلى مجال أكثر عدائية وتصادمية. على سبيل المثال، صنفت استراتيجية الأمن القومي لإدارته لعام 2017 الصين بأنها "مراجعة" واتهمت بكين بالسعي إلى "تشكيل عالم مناهض للقيم والمصالح الأمريكية" (White House, 2017). كان هذا تناقضًا صارخًا مع استراتيجية الأمن القومي لعام 2015 التي نشرتها إدارة أوباما، والتي "رحبت بصعود الصين المستقرة والسلمية والمزدهرة" وسعت إلى "تطوير علاقة بنّاءة... تحقق فوائد لشعبينا" (White House, 2015, p. 24). دوليًا، كان خطاب ترامب مثيرًا للجدل، خاصة بين الشركاء والحلفاء في آسيا الذين شعروا بعدم اليقين بشأن التزامات واشنطن الإقليمية (Oliva, 2019).
مع ذلك، وعلى الرغم من أن خطاب ترامب اليومي بشأن الصين كان في نواحٍ كثيرة غير متوقع - مع تصريحات عاطفية واستفزازية تسببت في تناقضات - إلا أن موقفه السياسي بُني أيضًا على اتجاهات طويلة الأمد (Turner and Kaarbo, 2021). كما سبق الإشارة، كان المسار الطويل الأمد للعلاقات الأمريكية-الصينية يتجه بالفعل نحو زيادة انعدام الثقة والعداء. على وجه الخصوص، شهدت السنوات الأخيرة من رئاسة أوباما تبني إدارته موقفًا أكثر صرامة تجاه بكين (Gries, 2020)، في قضايا مثل التجسس السيبراني، ونقل التكنولوجيا القسري، والتوسع الإقليمي الصيني في بحر الصين الجنوبي. لذا، من الخطأ الادعاء بأن ترامب أطلق مسارًا جديدًا تمامًا للسياسة الأمريكية تجاه الصين. على سبيل المثال، خلال حملتها الرئاسية لعام 2016، صرحت هيلاري كلينتون بأن الصين "تلاعبت بالنظام لفترة طويلة"، وأن "التعريفات الجمركية المستهدفة" كانت خيارًا ضد الدول التي "تنتهك القواعد" (Gorman, 2016). وبعد توليه منصبه في أوائل عام 2021، اختار الرئيس جو بايدن الحفاظ على التعريفات الجمركية التي فرضها سلفه.
بدأت رئاسة بايدن وسط جائحة كوفيد-19 العالمية، حيث تفاقمت التوترات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين. مع تحديد الصين كمصدر لتفشي المرض، واتهامات بأن الحزب الشيوعي الصيني أخفى خطورته في مراحله المبكرة (Yang, 2021)، تدهورت صورة الصين في الرأي العام الأمريكي بشكل حاد. كما ساءت العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبكين، لا سيما بعد أن انضمت وزارة الخارجية الأمريكية إلى جهات أخرى في إعلان أن الحكومة الصينية ترتكب إبادة جماعية ضد أقلية الأويغور في البلاد (Department of State, 2021).
في هذا السياق، ركزت سياسة بايدن تجاه الصين على تعزيز التحالفات مع الشركاء، لتجهيز واشنطن بشكل أفضل للاستجابة للتحديات التي يُنظر إلى أن الصين تفرضها. وبالإشارة إلى الحوار الأمني الرباعي بين الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، أوضح بايدن في أوائل عام 2021: "سأدعو تحالفًا من الديمقراطيات لمناقشة المستقبل. وسنحاسب الصين على اتباع القواعد" (White House, 2021b). كما عبرت إدارة بايدن عن نيتها "معالجة التحديات التي تطرحها الصين على النظام الدولي القائم على القواعد" (White House, 2021c).
تُطرح تساؤلات حول ما إذا كان العالم يدخل حربًا باردة جديدة مع وجود الصين والولايات المتحدة في مركزها (Schoen and Kaylan, 2014). ومع ذلك، فإن هذا الرأي قد يكون إشكاليًا ومبسطًا للغاية. فعندما يتحدث بايدن عن التزام الصين بـ"نظام قائم على القواعد"، فإنه يعيد صياغة التصورات التي ترى الصين ككيان منفصل عن المجتمع الدولي المتخيل (Turner, 2016). وهكذا، وبينما تتزايد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، فإن العوامل التاريخية والأيديولوجية تلعب دورًا لا يمكن تجاهله في صياغة هذه العلاقة المتوترة.
في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، أدخل دونالد ترامب خطابًا أكثر صخبًا وتصادمية. فقد صرّح بأن الصين مذنبة بـ"اغتصاب" الولايات المتحدة (BBC, 2021) وأنها "تمتص دماءنا" (Santucci, 2015)، في محاولة لتقديم نفسه كمدافع عن المصالح الأمريكية التي تم استغلالها، بدلاً من خدمتها، من خلال تعميق التكامل مع الصين. أدى هذا إلى ملاحظات بأن ترامب كرئيس قد أدخل اضطرابًا جديدًا وغير متوقع في علاقة أمريكية-صينية كانت مستقرة نسبيًا من قبل (Daojiong, 2017). من الأمثلة المبكرة على هذا النهج مكالمة ترامب الهاتفية مع رئيسة تايوان تساي إنغ ون في ديسمبر 2016، والتي كسرت الأعراف الدبلوماسية التي استمرت منذ عام 1979 والتي تنص على عدم تواصل رؤساء الولايات المتحدة (أو رؤسائها المنتخبين) مباشرة مع رئيس تايواني. وبعد ذلك بوقت قصير، شكك في منطق سياسة الصين الواحدة قبل أن يعيد الالتزام بها لاحقًا (BBC, 2017).
سياسة الصين الواحدة هي اعتراف واشنطن بجمهورية الصين الشعبية كممثل وحيد للصين، وبالتالي فهي تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين بدلاً من تايبيه. كما أنها تعني الاعتراف بموقف الصين (مبدأ الصين الواحدة) بأن تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، ولكن دون الموافقة على هذا الموقف (Bush, 2017). يسمح هذا للولايات المتحدة بدعم وحتى الدفاع عن تايوان، عبر قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، الذي تم توقيعه لتعويض انسحاب واشنطن من العلاقات الدبلوماسية مع تايوان لصالح بكين. وعلى الرغم من أنه ليس معاهدة دفاع ملزمة، إلا أن القانون يسمح بدعم وبيع المعدات العسكرية لتايوان. وقد أيدت هذه السياسة جميع الإدارات الأمريكية منذ دخولها حيز التنفيذ، وكان ترامب الزعيم الوحيد الذي تساءل علنًا عن قيمتها.
أكدت الجدل الذي أثارته مكالمة ترامب مع تساي إنغ ون، إلى جانب عدم يقينه الواضح بشأن سياسة الصين الواحدة، الأهمية المستمرة لتايوان في العلاقة الأمريكية-الصينية. وبالتشكيك في السياسة، كان يُنظر إلى ترامب في بكين على أنه يقوض سيادة الصين، لأن ذلك يشير إلى أن فكرة "وجود صينين" - وربما وجود تايوان مستقلة - لم تعد غير واردة في واشنطن. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين "قلقة للغاية" بشأن تداعيات تصريح ترامب على وحدة أراضيها (Chin, 2016). كما احتجت بكين منذ فترة طويلة على بيع المعدات العسكرية الأمريكية لتايوان، وهو أمر أيدته كل إدارة أمريكية في حقبة ما بعد الحرب الباردة.
أدى خطاب ترامب غير المتوقع تجاه الصين إلى عواقب محلية ودولية. محليًا، دفع ترامب الخطاب السياسي حول الصين إلى مجال أكثر عدائية وتصادمية. على سبيل المثال، صنفت استراتيجية الأمن القومي لإدارته لعام 2017 الصين بأنها "مراجعة" واتهمت بكين بالسعي إلى "تشكيل عالم مناهض للقيم والمصالح الأمريكية" (White House, 2017). كان هذا تناقضًا صارخًا مع استراتيجية الأمن القومي لعام 2015 التي نشرتها إدارة أوباما، والتي "رحبت بصعود الصين المستقرة والسلمية والمزدهرة" وسعت إلى "تطوير علاقة بنّاءة... تحقق فوائد لشعبينا" (White House, 2015, p. 24). دوليًا، كان خطاب ترامب مثيرًا للجدل، خاصة بين الشركاء والحلفاء في آسيا الذين شعروا بعدم اليقين بشأن التزامات واشنطن الإقليمية (Oliva, 2019).
مع ذلك، وعلى الرغم من أن خطاب ترامب اليومي بشأن الصين كان في نواحٍ كثيرة غير متوقع - مع تصريحات عاطفية واستفزازية تسببت في تناقضات - إلا أن موقفه السياسي بُني أيضًا على اتجاهات طويلة الأمد (Turner and Kaarbo, 2021). كما سبق الإشارة، كان المسار الطويل الأمد للعلاقات الأمريكية-الصينية يتجه بالفعل نحو زيادة انعدام الثقة والعداء. على وجه الخصوص، شهدت السنوات الأخيرة من رئاسة أوباما تبني إدارته موقفًا أكثر صرامة تجاه بكين (Gries, 2020)، في قضايا مثل التجسس السيبراني، ونقل التكنولوجيا القسري، والتوسع الإقليمي الصيني في بحر الصين الجنوبي. لذا، من الخطأ الادعاء بأن ترامب أطلق مسارًا جديدًا تمامًا للسياسة الأمريكية تجاه الصين. على سبيل المثال، خلال حملتها الرئاسية لعام 2016، صرحت هيلاري كلينتون بأن الصين "تلاعبت بالنظام لفترة طويلة"، وأن "التعريفات الجمركية المستهدفة" كانت خيارًا ضد الدول التي "تنتهك القواعد" (Gorman, 2016). وبعد توليه منصبه في أوائل عام 2021، اختار الرئيس جو بايدن الحفاظ على التعريفات الجمركية التي فرضها سلفه.
بدأت رئاسة بايدن وسط جائحة كوفيد-19 العالمية، حيث تفاقمت التوترات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين. مع تحديد الصين كمصدر لتفشي المرض، واتهامات بأن الحزب الشيوعي الصيني أخفى خطورته في مراحله المبكرة (Yang, 2021)، تدهورت صورة الصين في الرأي العام الأمريكي بشكل حاد. كما ساءت العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبكين، لا سيما بعد أن انضمت وزارة الخارجية الأمريكية إلى جهات أخرى في إعلان أن الحكومة الصينية ترتكب إبادة جماعية ضد أقلية الأويغور في البلاد (Department of State, 2021).
في هذا السياق، ركزت سياسة بايدن تجاه الصين على تعزيز التحالفات مع الشركاء، لتجهيز واشنطن بشكل أفضل للاستجابة للتحديات التي يُنظر إلى أن الصين تفرضها. وبالإشارة إلى الحوار الأمني الرباعي بين الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، أوضح بايدن في أوائل عام 2021: "سأدعو تحالفًا من الديمقراطيات لمناقشة المستقبل. وسنحاسب الصين على اتباع القواعد" (White House, 2021b). كما عبرت إدارة بايدن عن نيتها "معالجة التحديات التي تطرحها الصين على النظام الدولي القائم على القواعد" (White House, 2021c).
تُطرح تساؤلات حول ما إذا كان العالم يدخل حربًا باردة جديدة مع وجود الصين والولايات المتحدة في مركزها (Schoen and Kaylan, 2014). ومع ذلك، فإن هذا الرأي قد يكون إشكاليًا ومبسطًا للغاية. فعندما يتحدث بايدن عن التزام الصين بـ"نظام قائم على القواعد"، فإنه يعيد صياغة التصورات التي ترى الصين ككيان منفصل عن المجتمع الدولي المتخيل (Turner, 2016). وهكذا، وبينما تتزايد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، فإن العوامل التاريخية والأيديولوجية تلعب دورًا لا يمكن تجاهله في صياغة هذه العلاقة المتوترة.